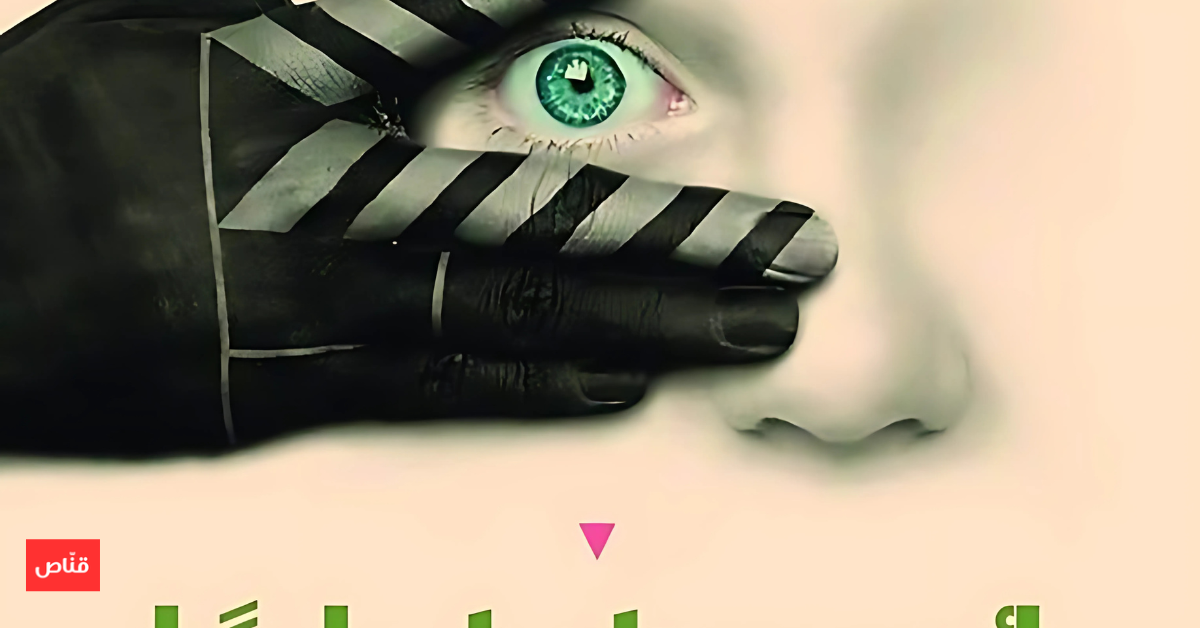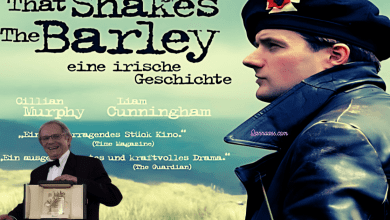أربعون فيلما وفيلم

هذا الكتاب ليس عن المصادرات، ولكنه عن الجمال، عن متعة لا تنفد، عابرة للأجيال، كامنة في أفلام أطول عمرا من صناعها، هنا قراءة لأفلام مختارة اكتسبت طابعا إنسانيا كونيا، وبعضها ترك تأثيرا تجاوز زمانها ومكانها، وربما يرى الذين أصابتهم أطياف من الفنون، على اختلاف الثقافات وتفاوت درجات الوعي، أن السينما أجمل «حقيقة إبداعية» اهتدى إليها الإنسان في نهاية القرن التاسع عشر، ولا يتخيل المؤلف في القرن العشرين وما بعده من دون السينما، أروع خيال خلقه الإنسان وصدّقه، ولولا السينما لكان القرن الذي شهد حربين عالميتين فقيرا، أغنته السينما، ولم تتأخر عن التنديد بمشعلي الحروب، والدفاع عن شرف الإنسان، وحقه في السلام والحرية والأمان والكرامة.
وقد آثر الكاتب الصحفى سعد القرش مؤلف الكتاب (أربعون فيلما وفيلم- دار الخريف – تونس/2024) الاكتفاء بأربعين فيلما وفيلم، وأستهل البداية بباب يضم كلاسكيات عابرة للأزمنة والثقافات، وتمتاز بالتنوع، من أمريكا إلى دول أوروبية، ومصر بالطبع، أما الأفلام الحديثة فهي تقريبا تقدم ملامح للسينما في بلادها موضوعيا وجماليا، من أمريكا اللاتينية حتى إيران وبنجلاديش شرقا وإفريقيا في العمق، في الظاهر أنها أربعون فيلما وفيلما، لكن في متن الكتابة العشرات من الأفلام المشار إليها والتي تنتظر كاتبا يخصص لها كتبا.
كانت البشرية، حتى نهايات القرن التاسع عشر، قد وضعت ملامح الفنون الستة: العمارة، والموسيقى، والرسم، والنحت، والشعر، والرقص. وبدلا من الاستقرار والاطمئنان، هبّت عاصفة السينما، عصا موسى، فنّا سابعا «يلقف» ثمار الفنون السابقة ويضيف إليها، ويحتفظ لنفسه باسم يستعصي على الترجمة إلى لغات الشعوب. ظلت السينما «سينما»، كلمة واحدة دخلت كل اللغات تقريبا، واستقرّت باعتبارها «سينما». وخلق الفن السابع لغة التواصل مع مشاهديه، والأوفر حظّا من الجمهور هو الذي يتلقى الفيلم بالحواس كلها، ولا تخذله السينما، ولن يفلت من أن تمسّه جمالياتها، وتصيبه فتنتها، وتفجّر في روحه ما لم يكن على دراية به.
يشير القرش الى أن السينما تتيح لمشاهديها ديمقراطية التلقي، منهم من تأسره حكاية الفيلم، ومنهم من يشغله فضاء الكادر وعلاقات الألوان والظلال، وفلسفة الحوار، ومنهم من يتجاوز ضيق الحكاية وتستهويه أفلام تميل إلى التجريد، وتقتصد في الحوار، وهذه أعمال تحتاج إلى مجاهدة، فلا تمنح نفسها من المشاهدة الأولى، وتتوجه إلى مشاهد غير مدلّل، صبور لا يبحث عن عنوان أو غاية لمقطوعة موسيقية أو عمل تشكيلي مركّب، كما يلازم السينما مرض اسمه الرقابة، وأنصبة هذا المرض تزيد وتنقص، تبعا لإدراك أنظمة الحكم لأهمية السينما. مثل: التعلل بالخوف على وجدان المسلم يشبه الخوف على وجدان المصري. في عام 1977 أيضا رفضت الرقابة في مصر الفيلم التسجيلي «لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء» الذي أخرجه اللبناني برهان علوية عن المهندس المصري حسن فتحي صاحب مشروع عمارة الفقراء، التهمة الجاهزة هي (الإساءة إلى سمعة مصر)، وقد أنصف الزمن هذا الفيلم ففي الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة (2019) عرض الفيلم، ضمن تكريم برهان علوية تضمّن إصدار كتاب عن سيرته الفنية للناقد اللبناني نديم جرجورة. وللخوف من الخيال تاريخ، بعد اجتياحات هتلر لجيرانه، وقرار الحلفاء التصدي له، تمثّل خيال شارلي شابلن جنون «الدكتاتور»، كان «الدكتاتور العظيم» فكرة، مشروع فيلم أخاف الألمان أكثر من طائرات الحلفاء. سارع كل من السفير الألماني وجورج كيسلنح قنصل ألمانيا النازية في هوليوود إلى مقابلة مسؤولين أمريكيين ورجال المال الحاكمين لصناعة السينما. هدّد الرجلان بمقاطعة ألمانيا للأفلام الأمريكية، إذا أصرّ شابلن على إنتاج «الدكتاتور العظيم». جرت مفاوضات لمقايضة الفنان الكبير وتعويضه، وإغرائه ماديا؛ لينصرف عن مشروع الفيلم، ولكنه راهن على ما يبقى، وأيقن أن غير الطبيعي إلى زوال، مهما تكن المكاسب السريعة للمعارك، فهي مؤقتة، أما الحرية فسوف تنتصر، ويصير «الدكتاتور العظيم» ذكرى لا تشرّف الألمان أنفسهم، ولم تكن الصحافة الأمريكية الاحتكارية الرأسمالية تعترض على التوجهات النازية، حين أنتج الفيلم وعرض عام 1940. شابلن قال إنه، بهذا الفيلم، يشارك في الحرب من أجل الحرية.
ولم يكن النازي وحده الخائف من السينما, كان الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني سبّاقا إلى ترويض هذا الوحش، فأسس مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1932، وفي عام 1935 أنشأ معهد السينما، وبعد عامين أقام في روما مدينة السينما (Cinecittà) أكبر مؤسسة إنتاج سينمائي في أوروبا لكي تنافس هوليوود، ولكن المدينة التي أراد موسوليني أن تنتج أعمالا دعائية أو تمجد الدولة، استهدفتها قوات الحلفاء، انتهت الفاشية بسقوط الزعيم، وعادت السينما كما حلم بها أنطونيو جرامشي «أداة أرخص وأكثر شعبوية من أي أداة فنية أخرى، أكثر من المسرح نفسه».
خارج أوروبا، حضرت السينما كأداة للهيمنة في يد الرجل الأبيض أشادت الناقدة الهندية أنجلي برابو، في كتابها البانورامي «السينما الإفريقية المعاصرة وسينما الشتات»، بالمخرجين الأفارقة الذين يكافحون من أجل «أفرقة عمليات التفكير»، في أفلام تحقق نوعا من التأمل المعرفي والجمالي والنقدي للذات الإفريقية وللعالم، ورصدت المؤلفة التمثيل العرقي للأفارقة في الأفلام التي صنعها الأوروبيون، إذ منعت بلجيكا مواطني الكونجو من دخول السينما في بلدهم، ثم سمحت لهم بمشاهدة أفلام ينتجها البلجيكيون، كما حظر القانون البريطاني الاستعماري على الأفارقة مشاهدة الأفلام الأوروبية والأمريكية، وكان الوجود الإفريقي في هذه الأفلام مشوّها، ويناسب التصور الكولونيالي للسود عموما، وأصدر بيير لافال (1883- 1945) وزير المستعمرات الفرنسي «مرسوم لافال» الذي يمنع الأفارقة من صنع الأفلام، وظل القانون ساريا حتى عام 1960.
وقد ارتبطت السينما منذ البدايات بالخوف والمصادرات. يُجهدني دائما إثبات نسبة المقولات الشائعة إلى أصحابها، أتعب ولا أصل إلى يقين. ولا أستطيع فضّ نزاع بين برنارد شو وهيجل، أيهما القائل «الشيء الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ هو أننا لا نتعلم شيئا من التاريخ»؟ وأميل إلى أنها لهيجل. وأيّا كان القائل، فالمقولة تثبت أن الحكمة أطول عمرا من صاحبها، وتؤكد أن العقول منزوعة الخيال، والسلطات المستأسدة بالقوة وحدها لا تريد أن تتعلم من التاريخ حقيقة عابرة للثقافات، ألا جدوى من مصادرة الفكر والإبداع؛ فقانون التاريخ ينتصر للمستضعفين ولو بعد مئات السنين، وينتقم من المستبدين بإسقاطهم من الذاكرة، وقد يرى التاريخ في النسيان رحمة بالمستبدين، فينتقم منهم انتقاما مضاعفا بألا يحتفظ لهم إلا بذكرى الحماقة. ولا يبقى إلا الرهان على الزمن في الغربلة، ونبل الاصطفاء، مع شيء من عزاء النفس بأن قدَر الحمقى أنهم محكومون بالغفلة، وأنهم ضحايا أنفسهم، ولا يتعلمون من تجاربهم، «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه».
ويذكر القرش انه في عام 1986، اجتمع في القاهرة وزراء الدفاع والداخلية والثقافة، لممارسة مهمة الرقابة على فيلم «البريء»، وفيه يُغرَّر بالجندي البائس أحمد سبع الليل (أحمد زكي)، ويشحن نفسيا لتعذيب «أعداء الوطن»، إلى أن يفاجأ بينهم بصديق طفولته الطالب الجامعي؛ ويحاول حماية صاحبه فيتعرضان معا للتعذيب والإهانة. ثم ينتهي الفيلم بسبع الليل في برج المراقبة يطلق النار على جنود المعسكر وضباطه وقائده الساديّ. وتأتيه رصاصة من أسفل فتقتله. كان الفيلم أكثر جرأة من قدرة الرقابة على التصريح بعرضه، فرأى الوزراء الثلاثة حذف عدة مشاهد أهمها المشهد الأخير، وعرض الفيلم من دون مشهد التصفية الجسدية. ثم أنصفه الزمن وعرض كاملا، عام 2005 في افتتاح المهرجان القومي للسينما المصرية.
وكما أن الموقنون بالزوال يخشون الخيال، ويعادون الكلمة والصورة، نجد الآلة الصهيونية عمدت إلى اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، ولا تزال قصصه ورواياته تؤرق النازيين الصهاينة في فلسطين. قال الجنرال موشي دايان إن قصيدة يكتبها شاعر مقاوم تعادل عنده عشرين فدائيا، الشعر هنا ليس أداة للحشد والتعبئة والنفير العام، ولكنه ذاكرة جمالية لا تزول.
بحسب المؤلف إذن الأفلام ليست مجرد تسلية، وإنما هي حفر في الوعي، وتأسيس لعلاقة تورّط الجمهور في علمية المشاهدة، وتحثه على التفكير. وقد حفظت السينما مشاهد، أسمى وأعمق من مجرد حكايتها، مأثورات لفظية أو مشهدية لا يملها المشاهد عبر العصور، مثلا في الفيلم الأمريكي «عطر امرأة»، يأمر مدير المدرسة طالبا فقيرا بالوشاية بزملاء ارتكبوا خطأ. الطالب الفقير «شارلي»، المساعد لقائد عسكري متقاعد فقد بصره في الحرب، يرفض الطالب، ويحال إلى لجنة تأديبية تحاكمه في مدرج يليق بمدرسة تستقطب أبناء رجال النفوذ والأثرياء. يستأسد المدير فيتّهم الطالب الصامت بالاحتيال والكذب، ويلوّح بحرمانه من الاستمرار في الدراسة، فينهض مرافقه المتقاعد الأعمى البصير، واصفا اللجنة التأديبية بأنها «ليست سوى مهزلة»، ويتهم مدير المدرسة ببناء «سفينة ليس فيها سوى الجرذان الوشاة، سفينة للخونة، وإذا كنت تعتقد أنك تعد هؤلاء الوضيعين أن يصبحوا رجالا فعليك أن تفكر مليا، لأنك تغتال ضمير كل من تزعم هذه المدرسة أنها تبنيه».

سعد القرش روائي مصرى, صدر له روايات: «حديث الجنود», «باب السفينة»، «المايسترو», و«ثلاثية أوزير»، «2067»، وجاءت روايته «أول النهار» فى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2008، كما فازت بالمركز الأول لجائزة الطيب صالح 2011، وفازت «ليل أوزير» بجائزة اتحاد كتاب مصر2009. له كتب/ شهادات منها: «الثورة الآن: يوميات من ميدان التحرير»، «في مديح الأفلام»، «سبع سماوات». فاز بجائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة 2009.
الكاتب المصري محمد عويس