الخرير
«البدء نختاره
لكن النهاية تختارنا
وما من طريقٍ سوى الطريق».
(سركون بولص)
خطوة أولى:
في مكان ما على هذه الأرض، وسنفترض أنه غير محدد، لأنه ليس مهما في هذا الهراء السردي؛ فليكن مجرد رصيف يظلله جدار قديم، تساقط ملاطه، مثلما تساقطت أسنان الشيوخ الثلاثة الذين تفيأوه، ذات أصبوحة صيفية، وهم يتابعون في صمت خرير نهر الحياة، وهو ينساب في صخب أليف، حيث تتداخل الأصوات والحركات – في ذلك الخرير – مستأنفة الاستمتاع بالغوص في نهر يواصل، وسيواصل، التدفق منذ الأزل، بينما الشيوخ يكتفون بالفرجة على مقربة من الضفة.
في الجوار، من شرفة بيت ما، يتناهى إلى مسامعهم شدو حسّون، غير مرئي، لكن صوته الشجي ينقر خرير نهر الحياة، حين انساب ماء الصنبور في مغسلة مطبخ البيت المجاور، وهم لا يعرفون أن نهرا ما يواصل الركض مبتهجا في ذاكرة العصفور، وكلما ركل الصنبور حنينه إلى البرية، أطلق العنان لنحيبه العذب.
أحد الشيوخ الواجمين، وكأن على رؤوسهم الطير قال إننا نشرب نفس الماء. اليوم قد نشرب هذه الكأس، وغدا قد نتجرع ماء قُلَّة شرب منها الأجداد. إنها دورة المياه، التي لا تتناقص منذ بداية الخلق، وتتكرر دورتها ما بين التسرب والتبخر، تتدفق في جدول أو قناة صرف صحي أو تتسرب إلى باطن الأرض؛ لكن هل يمكن أن تكون للحياة نفس الدورة؟ هل يمكن أن نعيش ونموت ثم نعود إلى الحياة في زمن آخر؟!
الزمن.. آه !! هذا هو اللغز المحير.. هل يمكن أن نتخلص من الإحساس به أو العيش خارج الزمن ؟! لماذا لا نستطيع التنقل برشاقة بين ضفتي الماضي والمستقبل؟ هل الزمن يغير جلده مثل الثعبان؟
صمت الشيخ برهة، ومن محجريه الغائرين تسيل نظرات حزينة ولامبالية، كما يجدر بمن أفنى عمره في عمل لم يختره، فاكتشف أن هذا العمر ضاع هباء، بين الخردوات البشرية، وكمن يحسد العاطلين عن الحياة، متبرما من صدأ الأيام هتف في ضجر فصيح:
– أنا مثقل بهذا السجن الخفي، الذي يقاسمني كل شيء، بل آخذه معي إلى البيت، ينام في فراشي دون أن يخلع حذاءه، وأنسى مفاتيحه في جيبي دائما، ولا أستطيع الهروب منه، ولا يخطر في بالي أن أتخلص منه برمي المفاتيح في بالوعة. أحياناً، يطاردني حتى في الأحلام. السجن ليس جدرانا وسجّانا. السجن شيء خفي يسلبك من ذاتك، يسكن في داخلك، ويستطيع أن يتمدد في الزمكان. ما تفسير أن تحرص حتى في الآحاد وأيام العطل المدرسية على أن تستأنف قضاء مدتك العقوبية، غير المحددة.. مبكرا، فيتفاقم سخطك على كل شيء؛ على مكان بائس نَزَع ذكورتك مثل بغل، وحولك إلى شخص تافه، يفكر فقط في عربة الحياة المجرورة، التي تثقل كاهله؟! سجن استطاع أن يجعلك تؤجل أحلامك من أجل لا شيء، جعلك تختصر أمانيك في الستر وراحة البال، كما لو كنت امرأة بدوية مسنة، تخشى أن تداهم ابنتها العنوسة، وبعد هذا العمر الشقي يمكنك أن تفكر بصوت عال: لن تتصادى خطواتنا على هذه الطريق. تلك الطريق التي لا يمكن أن نمشي فيها مرتين، ومادام هناك ماض، حاضر ومستقبل.. فلن ينتهي هذا الأذى. لولا الخطيئة الأولى لما تكررت الآلام.. كنا سنكون الآن/ هناك في الجنة.
صمت الرجل الكئيب برهة، وهو يهمس لنفسه: «بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ»، وفي جلسته على الرصيف تمسك الضرير بطمأنينة عصاه، دليله في طريق ترهف السمع للخطو المتلعثم، بعد أن سرق السُكَّري بصره واغتال كل أحلامه، مد ساقيه فوق الرصيف، كأنما يستريح من وعثاء الحياة، لاذ بيقين الصمت، فترامى إليه صوت رفيقه، وهو يتحدث بنبرة استياء صاخبة: كل شيء صار غاليا إلا الإنسان.. في زمن يعبدون فيه إلها جديداً هو: الدولار، وبسبب هذا اللعين يكابد العالم بأسره.. أصبح الجميع مجرد «كومبارس» في مشهد سريالي، فلا تحدثني عن آلام هذه الأكذوبة الكبرى التي تدعى: الحياة، وكمن يتلصص على العالم الآخر ، قال:
– كل الأيام متشابهة. في كل أسبوع سبعة أيام.. لماذا لا نحذف أحدها، وليكن يوم الأحد مثلا؟ لماذا لا نمنح هذا اليوم عطلة، لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو حتى سنة.. سيكون للحياة طعم آخر، من دون هذا اليوم الكئيب؟!
في زمن ما، يسمونه المستقبل سنصبح جزءا من الماضي، وسيتحدثون بحنين فاحش عن ذلك الحاضر الأليم الذي تحول إلى ماض بهي يتحسرون عليه…
صمت الرجل الأصمُّ هنيهة، وهمس لنفسه: سيكون غيابك متلكئا، قاسيا، طويلا، موحشا…
ستسرقين من الأيام طعمها وأسماءها. لن أنشغل بالجمعة، لن أنتظر السبت ولن أبالي بالأحد، ولن أفكر في غربة بقية الأيام الميتافيزيقية، – فالألم ببساطة- لا يعرف العطل، ولا يتقاعد.
كل الأيام ستغدو يوما سرمديا، مدته عام كامل؛ يوم كئيب، جنائزي مثل شتاء لا يريد أن ينتهي، وكل ما سأدركه أن غيابك سوف يُنَكِّل بدموع هذا الطفل اليتيم: قلبي.
وحين تناهى إلى مسامعهم صوت أغنية بذيئة اللحن والكلمات صاخبا من سيارة فارهة مرقت بسرعة: «أحبك، يا حمار»، انفجر الرجال ضحكا، ولأن الضحك مُعْد، راح الرجل الأصم يضحك بعينين دامعتين، وهو يتذكر رأس ذلك الحمار الذي أطل من شباك القسم، وهو يشرح النشيد لتلاميذه في مدرسة تقبع تحت سفح جبل مشهور بزراعة نبات مخدر. في ذلك الجبل أُغْرِم بفتاة كانت ترعى الشياه بالقرب من المدرسة. كان كُلّما لمحها صرخ بهجة: لا تحدثيني عن الألم.. عن دموعي في عينيك.
كف عن الضحك، صمت برهة، كأنما تذكر شيئا مهما، ثم عاتب نفسه/ قلبه في أسى فصيح: هل كان ينبغي أن تلتقي نظراتنا، وتسددي رصاص عينيك نحو قلبي الأعزل؟! هل كان من الضروري أن تشي بوحشة القلب، وتَزُجّين بسىرب من الدموع في هذا الحداد الطويل، القادم.. اللاينتهي: غيابك؟!
هل كان ينبغي أن نمرح، هنيهة، في بستان ملتقى النظرات، ذات ربيع، لكي تزهر – الآن، غدا وبعد غد – هذه الدموع على قارعة هذا الحزن الأعشى؟!
وفي سراديب دواخله تردد صدى لن يسمعه سواه: في البدء كان الصوت، ذلك المطر البهيج، الذي يقضم تفاحة هذا الصمت في نَهَمٍ طفولي، قبل أن تغرد الشمس ذات شتاء.
ودون أن يودعهم غادر الرصيف، وهو يدفع دراجته النارية المتهالكة، التي يتلكأ محركها في الاشتغال، ولم ينتبه إلى أن قب جلبابه الصوفي الثقيل تدلى فوق وجهه، فلم يستطع أن يرفعه ويداه متمسكتان بالمقود. لم يسمع منبه حافلة نقل المستخدمين، وهي تحذره من المضي إلى حَتْفه بعينين مغمضتين، فواصل الرجل العجوز الركض بدراجته النارية المتلكئة، وهو في طريقه إلى بائع الكيف، لكي ينسى خدعة أم زوجته، التي عرضت عليه أن يبني قبر الحياة لابنتها فوق قطعة أرض تملكها الأم، قريباً من سفح ذلك الجبل، ثم استولت المرأة العجوز على البيت وحرمته من زوجته وأولاده.
خطوة أخرى:
لم ير الأعمى دم رفيقه، وهو في طريقه إلى البحث عن الكيف، بينما كان الثالث غارقا في غيبوبته المعتادة، ينظر إلى يده في وجوم وبلاهة، باحثا عن ذلك الثقب الذي لم يكن يعرف أنه مجرد ثقب مجازي، وبعد أن أضحى مقعدا، صار يردد دوماً: «قَعيد: (اسم). الجمع: قُعَداءُ، المؤنث: قعيدة، والجمع للمؤنث: قعيدات وقعائدُ. المُقْعَدُ: المصابُ بداء القُعاد»، وهو يشير بمسطرة وهمية إلى الجدار القريب منه، وللتخلص من جنونه الطارئ تلجأ زوجة ابنه إلى وضع قطرات مشروب منوم في الأكل، وتطلب من ابنها أن يضعه على الرصيف مع أصدقائه الذين لا تعرف لماذا مازالوا يواصلون العيش معنا، فينضم إليهم، وهو غائب عن الوجود، فاقد الإحساس بالزمن فوق كرسيه المتحرك، ويستعيد نزهاته في مدينة النوم؛ يغبط صديقه الأصم على أنه لا يسمع شتائم زوجة ابنه، التي لا تكف عن التذمر، وهو يدرك أنه لولا تقاعده الشهري الذي يُسْند البيت، ذلك البيت الذي أضحى فيه مجرد ضيف ثقيل، لرموه في الشارع، ويحسد الآخر على نعمة العمى، التي تقيه من رؤية قبح الزمن، القلوب والأماكن.
يغفو فوق كرسيه المتحرك في أيام منذورة للكسل العظيم، يسبح في تلك المنطقة الشفافة ما بين النوم واليقظة، وفي سورة الوسن يبدو العالم أكثر تسامحا، محبة وأمانا وأقل تطرفا، حقدا وعنفا، ثم تتدلى ذقنه فوق صدره، ويغفو.. تذوب خطواته في ذلك الوادي، المتحرر من أسر الزمن وسطوة المكان، يستقبلونه في مدينة النوم مبتهجين.
في ساحة عظمى يستلقون على الأرائك، يتحرر من أسر كرسيه المتحرك هناك، ويمدد ساقيه كبقية الرجال، الذين لا يفعلون أي شيء هناك، لا يعملون.. لا يَكدّون، لا ينتظرون آخر الشهر. هناك، الزمن سرمدي، يسبح في منطقة ضبابية شفيفة، وعند رؤية امرأة جميلة يتثاءبون، يكتفون بالتثاؤب. هكذا يتخلصون من الملل، التوتر والكآبة. ومن حاول لمسها، يُنفى خارج أسوار المدينة بتهمة خدش الحياء العام، وإلى الأبد، في عالم لا ينام، ويكابد العذاب الأزلي الأبدي.
خطوة للخلف:
أزف الظهر. غمغم الشيخ الضرير متذمرا من تأخر حفيده، الذي يمعن في جفائه، لأنه لم يذق حنان الجد، كبقية الأقران؛ لم ير الجد يتوغل في الطفولة، كبقية الأجداد، كلما شاخت أعمارهم.
تنفس الشيخ الصعداء حين جاءته خطوات حفيده على الرصيف، والتي يستطيع أن يميزها عن بقية الخطوات، وكأنما يتمتع بحاسة سمع طائر. توكأ على عصاه، وهو يشتكي من آلام مفاصله، مسح ببصره المنطفئ السماء في عتاب خفي، وأشار إلى حفيده إلى أنه سيؤجل الذهاب إلى البيت، ويريد الذهاب إلى مكان آخر.
– إلى أين، يا جدي ؟!
– إلى مخفر الشرطة..
نظر إليه الحفيد مشدوها، فغمغم الشيخ بكلمات مبهمة، بضجره المعهود، ثم صمت الشيخ برهة، ولعن عبودية العمل، الذي حرمه – من قبل – من راحة اليوم السابع، بعد أن أجبر على بيع الملابس المستعملة وسقط المتاع على أرصفة قاع المدينة، بعد فصله من الوظيفة، بيد أنه لم يستطع أن ينسى تلميذه الخائب، الذي ركل بضاعته البالية مستغلا سلطته في زهو مقيت، كأنما ينتقم من إخلاص أستاذ الفلسفة المشاغب في عمله حد التطرف، فابتلع مرارة الإهانة على مضض…
وهما يطآن عتبة المخفر، انهالت على ذاكرة الجد سياط العتاب.. داهمه صدى صوت زوجته الراحلة، كأنما تواصل وصايتها عليه، ومعاملته كمعتوه: «أنت لا تحب الأحد، لا تحب الغروب، لا تحب شتنبر، لا تحب يناير.. لا تحب الشتاء، لا تحب الصيف… هذا كثير! هل نطلب من الله أن يخلق لك زمنا خاصا بك وحدك؟!»، وكانت محاولاته تبوء بالفشل دوما، وهو يوضح لها – مرارا – أنه ليس كبقية البشر، وأنه لا يعرف سبب هذه الحساسية المفرطة تجاه الزمن، وكانت تصفعه بعبارتها القاسية: «أنت إنسان غير سوي!».
ارتعشت أطراف الشيخ، حين ترامى إليه صراخ الشرطي في وجهه، وهو يشير له بيده أن يغادر المكتب: «اغرب عن وجهي أيها المجنون…».
غمر الندى عيني الشيخ المعتمتين، مد يده العجفاء إلى محجريه الغائرين، مسح بكم ثوبه ما يشبه دمعة، لم يفلح في إخفائها، فكر أن يسأل حفيده عن انطباعات اليوم الأول للعودة إلى المدرسة، فأحجم عن ذلك، فقد خامره ذلك الحزن الغريب، الذي كان يداهمه في مطلع كل شتنبر.
لم يَسْتَسِغ الحفيد فكرة بلاغ ضد الزمن، ولن يصدق أن جده الضرير عاش ثلاثة أدوار في لقطة عابرة على رصيف الحياة، وغادر مخفر الشرطة، وهو يدفع دراجته النارية المتهالكة، فداهمته حافلة، ولم ير سائقها وركابها دمه وأشلاءه، وكذلك لم ينتبه أي أحد إلى غيابه، ولا أحد يعلم ما يمكن أن يفعله بعد عودته إلى الحياة، ليختار ميتة أخرى.
الكاتب المغربي هشام بن الشاوي


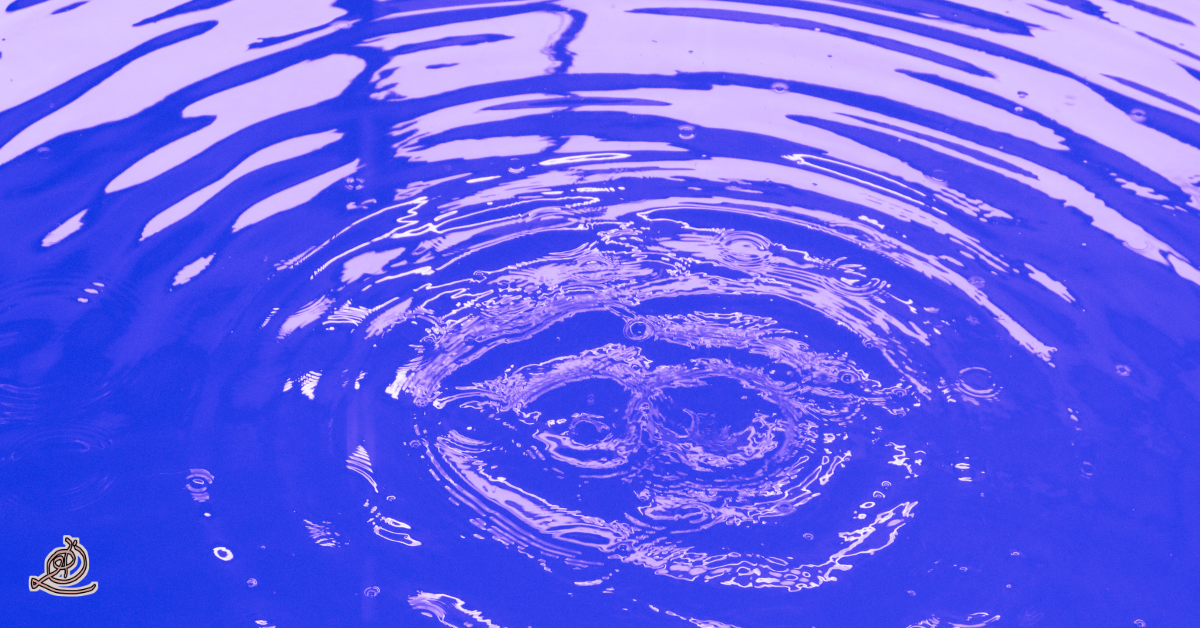
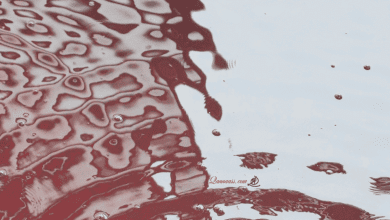




احسنت السرد